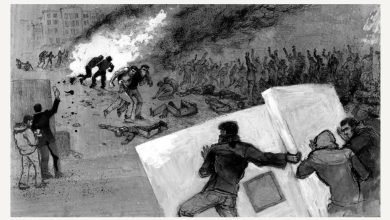ثـقـافة الـنّـفايات

إنّه يومٌ جميل. الشمسُ ساطعةٌ والعصافير تزقزقُ والسماء صافية. تمرّ بسيارتك على الجادة العريضة مدندنًا نغماتٍ تطربُ لها على مذياعٍ أطلقتَ له العنان. قررتَ أن تكون سعيدًا اليوم. رغم كلّ ما راكمتَهُ مِن سواد الأيام السابقة سيكونُ نهارُك هذا هانئًا.
تُفاجأُ بكيس بلاستيك يتطايرُ من جهةٍ مجاورة. تحوّل نظرك بحثًا عن المُرتكب فتقعُ عيناك على “سيّدٍ” متأنّق بماركاتٍ “عالمية” وساعةٍ ذهبية تتدلّى على معصمه تخبرك عن رصيدٍ مصرفيّ مُتخَم. السيّارةُ فارهة وطلاؤها البرّاق وهيكلُها الفخم يشي بسعرها الخيالي. لا يشعرُ “الحثالةُ” بفداحة ما اقترف. لا تلمحُ خجلًا على سحنتِه البلهاء. يتعكّر مزاجُك ويأخذُ منك الغضب كلّ مأخذ. ترفضُ أن تكون شريكًا صامتًا. تُساعدك عجقةُ السير كأنّها تدخّلٌ إلهيّ. تقتربُ مِن الجاني وتنهره بحنقٍ: “أما كنت تستطيع رمي قذارتك في سلّة المهملات؟”.
يلتفتُ بوقاحةٍ قلّ نظيرها متمتًا بصوتٍ جهور: “مش شغلتك، أنا حرّ!”.
لا تعرف من أعطاه “صكّ حرية” يخوّله اعتبار الطرقات ملكيةً سائبة والهواء صندوقًا مفتوحًا لنفاياته العضوية والنفسية. تراهُ كيسًا أسود مِن قاذورات الجهل والغرور. ما نفعُ الفخامة والماركات إن كانت نتانتُك تسبقُك بأشواطٍ منذِرةً الحجرَ والبشرَ بضحالة فكرك وفقر أخلاقك وحقارة نفسيّتك؟
تتذكّر- أنت الغيور على الوطن- بأنّ الأيادي العابثة هي نفسُها تلك التي ترتادُ الملاهي الليلية لِتسهرَ على أغانٍ وطنية تتغنّى ببلاد الأرز، وترقصُ عليها كأسودٍ تذود عنه عند الشدائد لتُسارع بعد حينٍ الى تلويث هوائه وشوارعه وشطآنه بخفّةٍ لا تُصدقّ. تتذكّر جيرانك المتباهين بحبّهم للوطن والرافضين في الوقت عينه تنفيذ قرارٍ للبلدية بفرز نفاياتهم، والساخرين منك على الملأ وعند كلّ سانحة لالتزامك بقرارٍ بقي حبرًا على ورق كونه مجرّد حملة طنّانة استُخدمت لتسويق لحظةٍ مناسبة ثم رميت إلى غياهب النسيان. تتذكّر زملاءك “المثقّفين” خريجي “أرقى الجامعات” الرافضين للمساهمة في نُبلِ “إعادة التدوير” ومشادّتك ذات يومٍ مع “نكرةٍ” استأجر محلًا من جارك أسفل بنايتك؛ فقطع بفأسه المسموم أغصان شجرة برتقالٍ غرست البلديةُ عشراتٍ منها على امتداد الحيّ وكنت تستأنسُ بشذى أزهارها وتكحّل عينيك بجمالها الى أن قضى عليها المجرم بفأسه اللئيم لأنّه ارتأى أنّ يافطته “ناولني” أولى منها بالبقاء. وفي جدالك معه دفاعًا عن الشجرة ينضم إليه جارُك مُستبسِلًا في حمايته لليافطة، متذرّعًا بـ”لقمة العيش”، ثم مُهدّدًا متوعّدًا بالضرب، مشيرًا الى بنطاله بحركةٍ عصبيّة صائحًا بأنّ “البلدية في جيبه” وبأنّه يدفع لها شهريًا ثمن تنصيبه زعيمًا لا يُرتدع على الحارة. واذ يلحظُ أنّه لم يخرجكَ عن طورِكَ يرميك بعبارة: “أتظن بأنّك أفهم منّا لمجرّد أنّك متعلّم؟”.
لا لن تحيد عن مبدئك قيدَ أنملة. ولن تثنيك فحيحُ التهديدات المُتواصل. ترى شرطيّ بلديّة على مقربةٍ من المكان. تهَرولُ إليه شاكيًا. يستمعُ إليك برحابة صدرٍ ثم يخاطبك بصوتٍ خافتٍ: “قطعُ الأشجار مهمّةٌ محصورةٌ بالبلدية؛ بس دخيلك هول زعران ما بدي إعلق معهم!”.
تشعرُ بالغثيان. الآلافُ بل الملايين في بلدِك التعيس أشبهُ بالأحياء الأموات المصابين بألف عقدةٍ وعلّةٍ نفسية وبالمتقاعسين عن الواجب. وهؤلاء المتقاعسون بالذات أصلُ العلّة؛ من رأسِ الهرم الى أصغرِ حاجبٍ على أبواب المؤسسات. كلّهم متواطئون في جريمة تغليب ثقافة “النفايات” على “نظافة” الأحياء والكفّ وعلى جعلك تخضعُ لِمنطقِ الخوف والاذعان للقوّة بدلًا من حثّك على مؤازرة الحقّ.
والدولةُ هذه لماذا لا تشعرُ بوجودها؟ تلك التي أمطرتك وعودًا بالعيش الرغيد قبل استلامها للمنصب، ثم تغاضت عن أكوام النفايات المُتراكمة على قارعة الطرقات؛ وعن المهانات التي تلحقُ بكَ من كلّ حدبٍ وصوب؛ فيما تصارِعُ صوتًا دفينًا ينصحُك بلا هوادة بالهجرة نحو فضاءاتٍ أجمل. تتساءل عن دور الجميع في تعزيز ثقافة “النفايات” وتكريسها قاعدةً روتينية، مِن مدارس وبلديات وإعلام وشعبٍ يؤثرُ العيشَ في قذارةِ أحياءٍ نتنة بدلًا من الارتقاء ممارسةً وأخلاقًا.
تنقذُك مِن السوداوية خطوةٌ سبّاقة لبلدية عاليه التي فرضت غرامةَ مائة دولار على كلّ من يُضبط راميًا النفايات عشوائياً في الشوارع. ليست الغرامةُ بحدّ ذاتها ما يثلج صدرَك، بل الرسالة الكامنة وراءها: لن نسمح بتحويلك مدينتنا إلى مكبّ. لن نتواطأ في جرم ثقافة “النفايات”.
تعيدُ إليك المبادرةُ، رغم بساطتها، بعض الأملِ بوطنٍ مؤجّلٍ لا يعرفُ القيامة. فهل نجرؤ بعد على الحلم؟